بنية الأدب الجاهلي في فكر حسين مروة
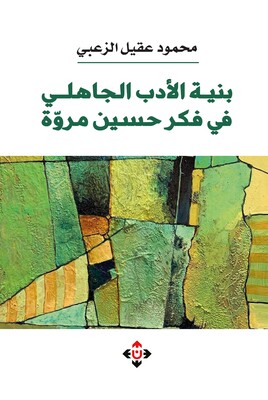
يمثل كتاب "بنية الأدب الجاهلي في فكر حسين مروة" للباحث محمود عقيل الزعبي، والصادر عن "الآن ناشرون" بالأردن (2025)، إضافة نوعية إلى حقل الدراسات الأدبية العربية، إذ يفتح أفقاً ظلّ مغلقاً طويلاً يتمثل في مساءلة العلاقة بين الأدب الجاهلي والفكر الماركسي في مقاربة البنى الثقافية والاجتماعية. فالكتاب لا يكتفي بإعادة قراءة النصوص الجاهلية من منظور تاريخي أو لغوي تقليدي، بل يسعى إلى إعادة تأويلها في ضوء مشروع نقدي وفلسفي متماسك استلهمه مؤلفه من تجربة المفكر اللبناني حسين مروة، صاحب الكتاب الموسوعي «النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» الذي شكّل علامة فارقة في النقاشات الفكرية العربية منذ سبعينيات القرن العشرين.
ينسب الباحث الفضل إلى مروة في أنه تجاوز القراءة التراثية السائدة التي حصرت الأدب الجاهلي في كونه مادة لغوية أو نصوصاً شعرية منفصلة، إذ عالج هذا الأدب بوصفه نتاجاً اجتماعياً وثقافياً مرتبطاً بالبنية القبلية للمجتمع العربي قبل الإسلام. وانطلاقاً من هذا المنظور، غدا الأدب الجاهلي انعكاساً لصراع طبقي، وتجليات للسلطة القبلية، وتعبيراً عن التوازنات الاقتصادية القائمة على الرعي والغزو والتجارة. وبذلك لم يعد الشعر الجاهلي مجرد أغانٍ للفروسية أو حِكم أخلاقية، بل وثيقة حيّة تكشف عن الوعي الجمعي للإنسان العربي ومخاوفه وتطلعاته في سياق تاريخي محدد.
جاء الكتاب في ما يزيد على مئة وخمسين صفحة موزعة على فصلين رئيسيين، يسبقهما تقديم بقلم د. غسان عبد الخالق وتمهيد، ويعقبهما خاتمة. تناول الفصل الأول صورة الأدب الجاهلي في فكر مروة، ووقف على قراءته للشعر والنثر والميثولوجيا، إضافة إلى موقفه النقدي من الدراسات الاستشراقية. وقد أبرز الزعبي كيف تعامل مروة مع الشعر بوصفه خطاباً اجتماعياً مشبعاً بالوعي القبلي، ومع النثر كأداة وظيفية مرتبطة بالحاجات العملية والسياسية للمجتمع، ومع الأساطير باعتبارها حكايات تفسّر المجهول وتخفف من وطأة المخاوف الجماعية.
أما الفصل الثاني، فقد تعمّق في تحليل الأنساق المعلنة والمضمرة في الأدب الجاهلي وفقاً لرؤية مروة، مظهراً كيفية ربطه بين هذه الأنساق والفلسفة الماركسية من جهة، والواقع الاجتماعي-الاقتصادي للعصر الجاهلي من جهة أخرى. وتجلّت أهمية هذه المقاربة في توظيف مروة لمفاهيم مثل البنية التحتية والصراع الطبقي والوعي الاجتماعي بوصفها أدوات إجرائية لقراءة النصوص القديمة، وهو ما أتاح له تجاوز الحدود الضيقة للقراءة الجمالية التقليدية.
وقد ناقش الباحث مجموعة من القضايا الجوهرية التي عالجها مروة في إطار الأدب الجاهلي، من بينها نظرته إلى الشعر باعتباره تعبيراً جماعياً أكثر من كونه إبداعاً فردياً، ونتاجاً مباشراً للقبيلة ومصالحها. فالمعلقات، في هذا التصور، ليست مجرّد نصوص فنية رفيعة، بل وثائق تجسّد منظومة القيم التي حكمت المجتمع القبلي، مثل الفروسية، والثأر، والكرم، والولاء. أما النثر، فقد تمثّل أساساً في الخطب والأمثال التي تُعد معالم تاريخية تعبّر عن تطور وعي الجماعة، وعن منظومة القيم الناظمة لسلوكياتها.
وفي ما يتعلق بالميثولوجيا الجاهلية، اعتبرها مروة خزّاناً خيالياً واجه به الإنسان المجهول، لكنها تحمل في جوهرها بعداً اجتماعياً يكشف محاولات العقل الجمعي تفسير الطبيعة والقدر. كما رفض القراءة الاستشراقية التي عالجت الأدب الجاهلي من خلال فرضيات خارجية مسبقة، مؤكداً ضرورة دراسته في ضوء شروطه المادية الداخلية. وفي هذا السياق، ميّز بين النسق المعلن للأدب الجاهلي المتمثل في اللغة والصورة والموضوع، والنسق المضمر الذي يتجلى في البنى الاجتماعية والاقتصادية الكامنة، من صراع طبقي، وهيمنة قبلية، وتشكّل أولي للوعي الجماعي.
يقدم هذا الكتاب نموذجاً تطبيقياً فريداً في النقد العربي الحديث، حيث يزاوج بين الأدب الجاهلي والفكر الماركسي في مقاربة جديدة للتراث، تُعيد النظر في النصوص القديمة باعتبارها معطيات قابلة للتأويل وفق مناهج معاصرة. كما يسهم في تجديد النقاش حول العلاقة بين الأدب والواقع الاجتماعي، بعيداً عن القراءات التمجيدية أو الجمالية الخالصة، ليمنح الأدب الجاهلي راهنيّة فكرية جديدة، بوصفه أحد أشكال الوعي العربي الناشئ في مواجهة أسئلة السلطة والحرية والوجود. وتكمن قيمة الكتاب أيضاً في كونه يعرض من جهة آليات مروة النقدية في قراءة الأدب الجاهلي، ومن جهة أخرى يقوّمها، كاشفاً عن حدودها وإمكاناتها، ليغدو بذلك إسهاماً في تطوير حقول الدراسات الأدبية والفكرية في آن معاً.
















