فاتن المر في حوار مع ديوان العرب
موجز السيرة الذّاتيّة للضّيفة:
كاتبة لبنانيّة، حائزة على شهادة الدّكتوراه في اللغة الفرنسيّة وآدابها
نُشرت لها عدّة دراسات نقديّة باللغة الفرنسيّة
صدرَ لها:
قصص: بين انتظارين
روايات: الزمن التالي، الخطايا الشائعة، مفتاح لنجوى
حديثي عن الخيام، غبار، حيث يبدأ الصدع
فاتن المر: "بيروت... تمثل كل مدينة مجروحة ومهددة في بلادنا المنكوبة، تمثل غزة وغيرها من المدن النازفة والصامدة".
نبدأ حوارنا من روايتك الجديدة (إرثُ بيريت)، وبيريت كلمة فينيقيّة تعني "الآبار"، في إشارة إلى وجود الآبار الجوفيّة في موقعها، ومنها سُمّيت بيروت.
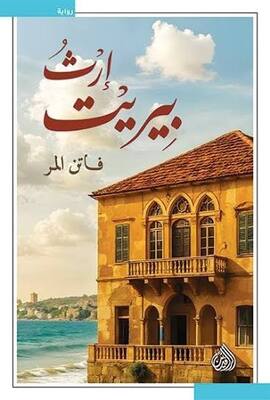
لماذا بيريت، وليس بيروت، هل للمعنى الفينيقيّ رمزيّة على أنّ الرّوايةِ مرتبطة بالأرض كارتباط الآبار بها؟
كتبت هذه الرواية في زمن الحرب الأخيرة حيث كان عليّ أن أبحث عن متمسك للأمل الذي كان يسقط في هاوية حرب الإبادة والتوحش التي كانت تشن علينا. بطبعي لا أستكين ما لم أجد منفذاً لمتاهة الحزن التي كانت تحاصرني، ما لم أجد كوة يتسرب منها الضوء. كان لي صديق يردد حين تشتد الصعوبات مثلاً شعبياً يقول: "الدني بتهز وما بتوقع"، وقد أكون لا شعورياً تمسكت بهذا القول لكي لا أخاف على بلادنا من السقوط، فكان أن فكرت بكل الأزمات التي مرت بها بيروت، فتعثرت، ثم ما لبثت أن داوت جراحها وقامت مجدداً. هكذا كانت رحلة نحو تاريخ بيروت، منها الحقبة الفينيقية، حين كان يطلق عليها اسم بيريت، رحلة استرجاع للعذاب والوجع، بسبب نكبات منها عدوانية استعمارية ومنها طبيعية، ولكن أيضاً للصمود والبقاء. أما فيما يتعلق بمعنى "مدينة الآبار" فأرى فيه رمزاً للماء، والماء حياة تقبع في عمق الأرض لتسعف سكان الأرض متى احتاجوها. لكن بيروت هنا لا تعني نفسها فقط، بل هي تمثل كل مدينة مجروحة ومهددة في بلادنا المنكوبة، تمثل غزة وغيرها من المدن النازفة والصامدة.
..." قالت جدتي: "إنّ الحزن في بلادنا إرث.
متى تنتصر المقاومة، ومتى سنكفّ عن توريث الحزن للأجيال المقبلة؟
المقاومة تنتصر كلما وجدت، ففي الصراع بقاء وفي الرضوخ ضياع. المقاومة هي إرث حياة، هي حب على الرغم من كل الأحزان. لا يحزن من لا يشعر بالوفاء لوطنه، لا يحزن من لا يحب أرضه، لذلك، كلما كان حب البلاد كبيراً، كلما كان الحزن بسبب معاناتها عظيماً. قد تضعف المقاومة حيناً وتقوى أحياناً، لكن بقاءها يدلل على سريان الحياة في شرايين الوطن مهما اشتدت الأطماع حوله ومهما اشتد العنف الذي يمارس ضد عمرانه وسكانه.
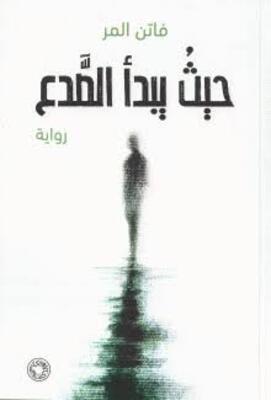
_ من روايتك (حيث يبدأ الصّدع):
«سأنصب خيمتي عند ناصية التاريخ، وأكتب لتلك الأجيال... لصدع يصعب أن تلتحم ضفتاه».
تعوّلين على التّاريخ كثيرًا في رواياتك، هل لدينا صدع واحد، أم صدوع لا تُحصى؟
يخيفني هذا البعد بيننا وبين تاريخنا، هذا الجفاء، تلك التغريبة... كيف لا يضيّع هويته ذلك الذي ينفصل انفصالاً تاماً عن تاريخه؟ وهذا حال الأكثرية بيننا. في رواية "حيث يبدأ الصدع" طرحت تساؤلاً حول أسباب التشظي الاجتماعي والنفسي، وكانت إحدى الإجابات صدع يعود إلى تقسيم البلاد وفقاً لأهواء ومصالح استعمارية بالتوافق مع أهواء ومصالح مجموعة من المستفيدين من أبناء الشعب. الصدوع كما قلت لا تعد ولا تحصى والنتيجة المأساوية انقسامات تفتك بالمجتمع على كل الأصعدة، وصولاً إلى نفسية الفرد.
هل الفعل المضارع في عنوان الرّوايةِ السّابقة دلالة على اليأس من أنّ هذا الصّدع لم نستطع التّخلّص منه منذ القديم؟
المعرفة قوة. لذلك فإن الإشارة التاريخية إلى موطئ الصدع ودمجها ضمن إطار متخيل فيه شيء من التشويق يدفع القارئ إلى التفكير في أسباب ما نحن فيه وفي ذلك وحده بداية الخلاص. على العموم، أنا أؤمن بالكتابة كما بالقراءة بصفتهما من أدوات النجاة للعقول وبالتالي للمجتمع. يعني ذلك أنني طالما أنا مستمرة في الكتابة، طالما أنا محصنة ضد اليأس.

_ في روايتك (غبار1918)، الفائزة بجائزة كتارا، تقولين:
"تمددت ألسنة اللهب من صفحة إلى أخرى مثل وحش ضارٍ يصر على التهام حروفنا منذ أن قرر التاريخ أن يقيدنا، ضحايا عند قدميّ غازٍ يليه آخر.”
هل نحن بحاجة إلى إحراق صفحات التّاريخ السّوداء، أم كتابة صفحات جديدة ناصعة؟
على العكس، كما سبق وقلت، نحن نتعلم من تاريخنا لكي يكون لدينا أمل ببناء مستقبل أفضل، مستقبل نتحرر فيه من المعتقلات التي نرضى أن نسجن داخلها.
_ جاء الإهداء في روايتك السّابقة إلى حفيدك (غدي)، هل هي أيضًا رمزيّة للغد، فكما قال أحد النّقّاد عنكِ:
فاتن... تقرأ التاريخ على أنه عنصر أساسي في تكوين الحاضر وتكوين المستقبل"؟
أنا أؤمن بغد أفضل تصنعه أجيال تحمل من الوعي ما يجنبها الوقوع في الأخطاء المدمرة لمن سبقوها.
_ لاحظتُ في مؤلّفاتك كثرة الرّوايات قياسًا للقصص القصيرة، ما الّذي تمنحه الرّواية للكاتب أكثر من القصّة؟
بدأت بكتابة القصة القصيرة، لكن، بالنسبة إلي، وجدت أن الرواية تسمح لي بالعيش وقتاً أطول مع الشخصيات. أنا أكتب كما لو كنت أقرأ: أتشوق للعودة إلى الرواية التي أكتبها لأستكشف خفايا حياة ونفسية الشخصيات كما لو كنت أكتشفها، أتشوق لمعرفة مصيرها ومآل الأحداث، وهذا ما تسمح به الرواية أكثر من القصة. لكنها مسألة ميل وذوق، فقد يكون لكاتب القصة أسباب عدة تجعله يرتاح لخياره هذا.
_ كونك متخصّصة في اللغة الفرنسيّة، هل لديك مشاريع ترجمة أدبيّة، وكيف تبدو حركة التّرجمة في لبنان؟
في الحقيقة، حتى الآن لا أستسيغ الترجمة كثيراً، فأنا أفكر بالفرنسية حين أكتب بهذه اللغة وبالعربية حين أكتب بلغتي، ولا أملك رشاقة المترجم الذي يسهل عليه التنقل من لغة إلى أخرى. أقول حتى الآن، لأنني لا أنفي تماماً إمكانية تغير مزاجي مما يجعلني أرغب في خوض تجربة الترجمة يوماً ما.
أما عن حركة الترجمة في لبنان، فهي، مثل كل ميادين الثقافة، بعيدة بالإجمال عن المستوى المطلوب، متأثرة في الآونة الأخيرة بالظروف السيئة التي نمر بها، منذ الأزمة الاقتصادية حتى الحرب التي لم تضع أوزارها بعد.
_ماذا عن الحركة النّقديّة في لبنان أيضًا، وهل النّقد يواكب ما يُطبع من أعمال أدبيّة؟
الحركة النقدية برأيي تنقسم بين دراسات أكاديمية لا تصل إلا إلى المتخصصين في المجال، ومقالات صحفية غالباً ما تكون سريعة وقد تبقى سطحية، أعتقد أنه قد يكون من المفيد التوصل إلى طريقة للجمع بين هذين الإطارين المتباعدين لإيجاد نقد أدبي عميق ومثير لاهتمام القارئ غير المتخصص,
_ بدأنا من بيروت، ونحتم حوارنا بها؛ عندما سُئلَ محمود درويش: هل تحب بيروت؟
قال: لم أنتبه، فنادرًا ما تحتاج إلى التأكيد من أنك في بيروت، لأنك موجود فيها بلا دليل، وهي موجودة فيك بلا برهان"
كروائيّة، هل تختلف نظرتك عن درويش؟
كيف تتأكّدين أنّك في بيروت؟
بيروت رمز ولد مع الأساطير المؤسسة لحضارتنا، بيروت فينيق يحترق ثم يبعث مجدداً، ينفض عنه غبار الموت ليحلق في فضاء متجدد. هي، ككل مدن بلادنا، تجسد دورة الحياة التي لم ولن تنقطع.
















