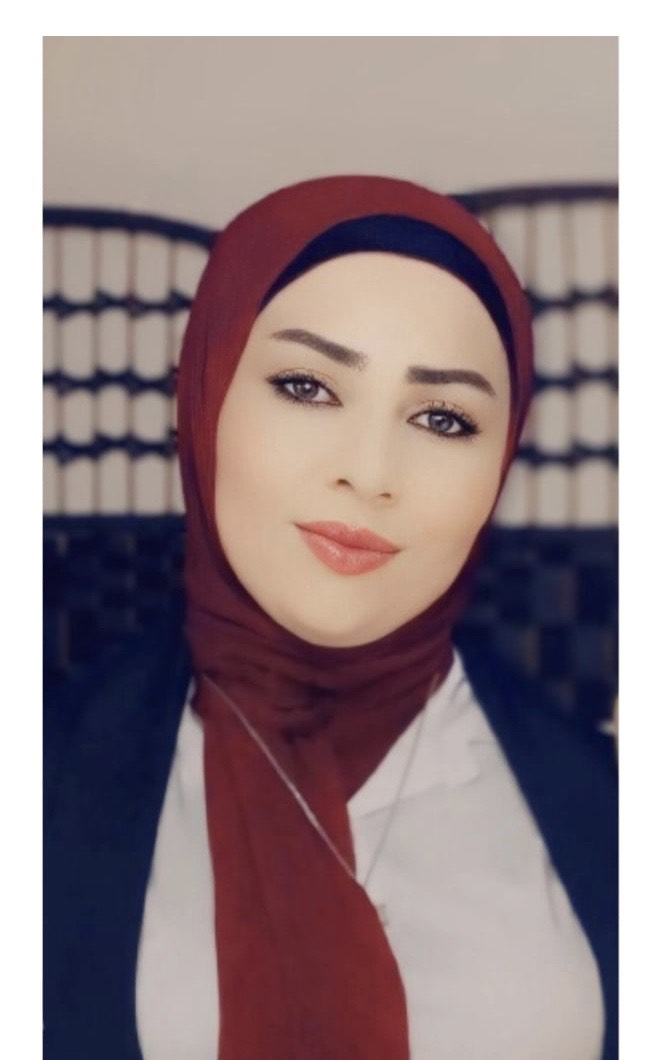غدير حميدان الزبون ابنةُ النجم والبئر والحرف

وُلدتُ على خاصرة التاريخ، في صباحٍ معلّق بين الشمس والريح، في الثامن عشر من حزيران عام ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وثمانين، يوم كانت الأرض تتهيّأ لولادة حكاية أخرى من حكاياتها العتيقة، في بيت لحم المدينة التي يهبطُ فيها الروح، وتنهضُ من قبابها البشارةُ الأولى، وتتنفّس حجارتها صلاة العذراء ونور النبوة.
أجل، ولدتُ على مقربة من بوابة القدس إلى السماء في بيت لحم المدينة التي إذا تنفّست فاض من رئتيها بخور، وإذا صمتت ارتفع من حجارتها صدى صلاةٍ أزليّة.
هنا، في طين مولدي يهبط الروح كالندى، وتنهض من القباب بشارةٌ، ويتهجّى الحجر اسم العذراء، فيعلو النور من ترابٍ لم يعرف الظلّ، وترتّل المزاريب نبوءةً نسيتها السماء.
أتعرفون مَن أنا؟ أنا ابنة هذا الحنين حفيدةُ النكبة، وسليلةُ الحكايات التي لا تموت.
أنا ظلالٌ من مجدٍ غابر، وصدى وطنٍ يُنادي من وراء الغيم، وُلِدتُ على خاصرة الزمان
حين كانت بيت لحم تنفض عن قباب حاراتها غبار النبوءات، وتغسل جدرانها ببخورٍ نازلٍ من فم ملاكٍ لا يُرى.
جئتُ لأصرخَ في المدى، وأهمسَ بترتيلةٍ أُخفيت طويلًا في صدر الغيم، وكلّ ما معي ومضاتُ حبٍّ في القلب لا تشيخ، ونجمةٌ من أفق الميلاد تضيء للغرباء طريقَهم إلى الفجر، إلى أول الخلاص.
لكنّ نجمةً أخرى كانت تُراقبني من الجهة الأخرى من الحلم، نجمةُ المالحة قريتنا التي خلعها المنفى من جدائل القدس، وطردوها من بين قُبّة وسور فنامت قرب الزيتون مثخنةً بالحنين.
كانت تحدّق فيّ من فجّ الغياب، تغمرني بضياءٍ فيه شيءٌ من النشيج، وتهمس لي لا في اليقظة ولا في المنام، بل في تلك البقعة الرمادية بينهما:
"عودي إليّ، أنا الأرضُ التي لا تموت، فأنا التي خبأتُ لكِ اسمكِ في زهر اللوز، ونظرتكِ الأولى في عنب الخليل، وصوتكِ في نحيب الكنائس ومآذن الفجر".
لا زلتُ بنتُ الطريق بين نجمتين: واحدة تضيء للغرباء، وأخرى تحترق كي لا أنسى.
جئتُ إلى هذا العالم وفي قلبي ومضاتٌ من الحب الملحمي، وعبقٌ من نجمةٍ ما تزال تُضيء طريق الغرباء إلى مهد الخلاص، فنشأتُ بين البشارة والمنفى، بين سرّة الأرض وملحها.
هناك، في شارع نجمة آبار النبي داود، وبين أزقته التي تحمل في حجارتها أنفاس المنفيين، تراكضت خلف فراشات صرخة البئر الأولى، ونهضتُ صغيرةً، أركض بين طيف جدتي فاطمة، ونبرة عمّي الحكيم خليل، ألاحق ظلالهم كما يلاحق العطشى المطر.
كانا مددي في الطفولة، عكّازي في أول الطرق، ونبضي حين خفتت الأصوات من حولي.
رحلا مبكرًا، لكنني منذ ذلك الزمن فهمت كيف تُبنى الأرواحُ على الحنين، وكيف يصير الفقد نهرًا يشقّ القلب ليروي الحرف.
وفي فناء مدرسة بنات عايدة الأساسية، التابعة لوكالة الغوث سُكِبت في قلبي أول قطرةٍ من مداد الحرف، أمسكت القلم، وكتبتُ:
"لماذا تختفي النجوم صباحًا؟"
ولم أكن أعلم أنّني بدأت يومها رحلتي الكبرى مع الضوء والغياب، مع الأسئلة والكتابة.
ثم كبرتُ بين دروب بيت لحم، ودرجتُ بثباتٍ من الابتدائيّة نحو الإعداديّة فالثانوية، أرتدي ظلّ جدتي، ووشاح أمي، ودمعة خفية على العم الحكيم، وشموخ والدي.
لم يكن الدرب مفروشًا بالياسمين، بل بالشوك والصبر، وبرسمٍ من خطى الصابرين، سرتُ فيه لا أتّكئ على ورد، بل على جراحٍ نبتت من ضلوعي، أرويها بالرجاء وأواصل المسير، فما من نعومةٍ في الحلم، وما من ظلّ يحنو، فقط شمسُ الحقيقة تلفح وجهي، وريحُ الإرادة تمضي بي.
كلّ خطوة خطوتها كانت امتحانًا، وكلّ عثرة تعثرت بها كانت صلاة، فأنا لم أطلب الدعة، بل طلبت معنى للوجع، وكلمة تُكتب بالأمل، وتُقرأ بالعين الثالثة، حيث لا يضلُّ القلب، وتعبق الروح برائحة الأرض وبصبرٍ كنعانيّ لا يشيخ، فكلّ وردةٍ نمت على جنباته وُلِدت من رماد، وكلّ ظلّ كان ثمرة حنين لا يموت.
هكذا خُلق الطريق لمن أراد أن يكتب اسمه على صفحة الخلود.
تزوّجتُ مبكرًا، وفي يدي كفّ طفلة، وفي اليد الأخرى كفّ حلم، لكنّ شغف الدراسة اشتعل في دمي، ولم تطفئه لا مهام البيت، ولا بكاء البنات، ولا فقر الظروف.
تابعت دراستي وأنا أحتضن بناتي الصغيرات وأطعمهن زاد العزّ والكبرياء، وأُطعم الحرفَ من رغيف الصبر.
وبقوة الإيمان والإرادة التحقتُ بجامعة القدس المفتوحة، أدرسُ اللغة العربية وآدابها عن بُعد، لكنني كنت أراها أقرب إلى قلبي من ظلّي.
ورغم أنني كنت أكتب واجباتي الجامعية بين نجمتين، وأحضّر للامتحانات على ضوء شمعة خجلى في ليالي الشتاء القاسية، فإنني لم أشتكِ، كنت أقول في قلبي:
"أنا لست أقلّ من سواي، بل أنا أكثر، ففي يدي أطفال، وفي رأسي كتب، وفي صدري وطنٌ صغير اسمه الأمل".
كم من مرة توقف نبض قلبي، وجفّ معه الحبر من قلمي، لكنني واصلت، كنت أمشي على الحواف بين المسؤوليات والدراسة، كأنني أسير فوق حبل مشدود فوق وادٍ من الإحباط، ولا شبكة أمان سوى إيماني بنفسي.
وفي الوقت الذي كانت بعض الزميلات يدرسن في هدوء المكاتب، كنت أدرس على وقع بكاء الطفلات، وفي الخلفية طنجرة على الموقد، وملابس معلّقة على حبل الحياة.
مرّ عليّ وقت شعرت فيه أنّ كلّ الأبواب موصدة، لكنني كنت أؤمن أنّ للعلم مفتاحًا لا يُصنع من ذهب، بل من صبرٍ وشغف.
كنت أفتح كتبي كلّ ليلة لا بيدي فقط، بل بروحي المتعبة التي آمنت أنّ الحرف نور، وأنّ النور لا يعرف الاستسلام.
مطارق شديدة الوقع على رأسي تدقّه دقّا دقّا، وتهمس في داخلي صوتًا يقول:
"إلى متى؟"
فأردّ عليه بصوت أعلى: "حتى أصل".
واليوم، وأنا أكتب هذه السطور لا أحتفل بنجاحي وحدي، بل بنجاح كل دمعة صمدت، وكل وجعٍ تماسك، وكل حلمٍ قاوم الانطفاء.
أنا امرأةٌ لم تُربِّ بناتها فقط، بل ربّت ذاتها من تحت ركام الحياة، وشيدت لنفسها مكانة في حرم الكلمة، وفي قلب اللغة.
أنا قصيدة كُتبت بالعرق، وسُطّرت على هامش الظروف، لكنّها اليوم تقرأ على منصّة الفخر.
كنت أكتب، أشرح، أُحلّل، وأنا أُطبطب على رؤوس صغيراتي، وأمنح لكلّ واحدةٍ من بناتي زهرةً وكتابًا، ثم تخرّجت امرأةً سكبت قلبها في حبر الرسالة.
وبدأت رحلة العمل متنقلةً بين المدارس الخاصة باحثةً عن غيمةٍ في صيفٍ لا يرحم.
إلى أن وجدتُ مكاني في وزارة التربية والتعليم معلّمةً، ثم باحثةً، ثم مشرفة تربوية في اللغة العربية، حيث أدركتُ أنّ الحرف لا يُدرَّس فقط، بل يُؤمن به ويُرعى ويُروى.
خلال رحلتي في التعليم التحقت ببرنامج الماجستير، وكنت أكتب رسالتي كمن يُنقّب في أعماق الذهب:
"النظم القرآني عند السهيلي من خلال كتابه نتائج الفكر".
وبين كل فصلٍ وفصل، كنت أغمس روحي في طيف فاطمة، وابتسامة خليل، وملامح بنتٍ تنتظر حضني في المساء.
وتخرّجت، ثم ارتقيت في عملي، ثم طُلبتُ للتدريس الجامعي، ووقفتُ أمام الطلبة لأقول للحرف:
"ها قد عُدتُ إليك، ومعي قبيلة من البنات والحكايات".
لكنّ شغف العلم لا يشبع، فشققت طريقي إلى الدكتوراة بعد التحاقي بالإشراف التربوي إلى تونس أرض الزيتون، حيث التحق قلبي ببحثٍ شعريّ ملحميّ عن سيميائية الألوان في ديوان محمود درويش "لا تعتذر عمّا فعلت".
كنت أدرس اللون الأحمر كأنني أرى دم شهيد، والأبيض ككفن أمّ تودّع ابنها، والأخضر كحناء الجدات في قرى المنفى.
وفي تلك الرحلة، نضجتُ لأكتب "باب على البئر الأولى بعد المالحة"، فكانت صرخةَ العودة الأولى.
وكتبتُ "يا بركات سيدنا الخضر حِلّي"، فاستدعيتُ أساطير النساء الحالمات على العتبات.
ثم همست "حين نادت عشتار"، فارتفعت الأرض وعادتِ الحكايات من رمادها.
أنا اليوم، غدير حميدان الزبون، لستُ مجرّد اسم في ملفّ وظيفي أو ورقة بحثيّة، أنا ابنة بيت لحم، من ترابٍ تنبّأ بالمحبة، ومن قرية المالحة التي لم تذبل رغم الخراب، ومن بئرٍ ما زال يروي قصص العودة، ويمنحني كلّ فجرٍ قطرة من المعنى.
أنا التي كتبت كي لا نُنسى، ووقفت على منابر الحرف لأقول لكلّ طفلةٍ:
"إن كنتِ تملكين حرفًا، فقد تملكين وطنًا".
أنا غدير...
حيثما كان الحرفُ، كان لي وطن، وحيثما كان الوطنُ، كان قلبي، وحيثما كنتُ... كانت اللغة تبعثني من جديد.
ابنة الحرف حين أضاء طريقًا في عتمة الغربة، وابنة الأرض حين نطقتْ حجارة المالحة باسم العائدين.
لم أكن سيرةً في سطر، ولا عنوانًا لوظيفة، كنتُ – وما زلتُ – النبضة الأولى لحكايةٍ كتبتها النساء على جدران الوقت:
أن تكوني من فلسطين يعني أن تكوني القصيدة والخريطة معًا.
وُلِدتُ من رحم بيت لحم، حيث يتنفس التُراب تراتيل الميلاد، وشببتُ على ناصية بئرٍ
ما زال يُلقي دلوه في ذاكرة الأمهات، ويُخرجُ الحنين ندًى، والغد قطرةً من نور.
أنا التي كتبتُ كي لا تصمت القرى، وصرختُ كي لا تتلاشى أسماء الينابيع.
كتبتُ لأغرس في كلّ طفلةٍ تحلم:
"اكتبي يا صغيرة، فالحرفُ مفتاحُ العودة، والقلمُ شجرةُ زيتونٍ لا تحترق."
أنا غدير...
حين تتكلّم اللغة، أنبتُ من بين جُملها سنبلة، وحين ينكسر العالم، أرتّق شروخه بالحكايات.
في كلِّ قصيدةٍ وطنٌ صغير، وفي كلِّ وطنٍ قلبٌ اسمه أنا.