حسانين.... في زاوية الروح
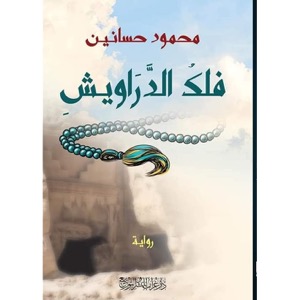
في روايته الاخيرة (فلكُ الدَّرَاويش) الصادرة عن دار غراب يناير ٢٠٢٣ م، يواصل محمود حسانين تأصيل معاناة العارفين بالله، في فُلك يسير، أو فَلك يدور، يتواصل كل أقطابه أو يتوارثون المعاناة في نسل، قد لا ينقطع.
في البداية يقرأ (جلال الدين) الحفيد كتاب جده ومسيرة الطريقة السراجية والتي ابتكرها الكاتب.
(كان بالقرب من الجبل طريق مليئة بالتراب والصخور، فعلم بأنه من الصعب السير في هذا الطريق، ولم يجد غيره فبحث عن طريق آخر كما أخبره الراعي فلم يجد، فعلم أن طريقه الثاني هو الصعود إلى الجبل، فنظر إلى أعلى، فعلم أنه شاق عليه تسلق الجبل لكي يصل لما وراءه، ولم يجد أمامه خيراً له غير الدخول إلى تلك المغارة التي بباطن الجبل، حتى يستريح ويتدبر حاله وما عليه أن يفعله) وكأنه يخبرنا، أن الوصول إلى الله لا يحتاج أن تتبع طريقة بعينها، يكفيك طريقتك الخاصة المكنونة في قلبك، إتبع ما يمليه عليك فهو بالتأكيد متصلا بخالقه، وهو الذي يُعرض عليه (جلَّ جلاله) في اليوم خمس مرات فلا يحتاج لهم.
وبرغم أن الثلث الأول من الرواية يخصصه الكاتب لترسيخ معاناة الوصل والترقي، داخل الأجيال السابقة ل (لجلال الدين)، كجده الأكبر (عبد الرحمن بن صفي الدين)، وأبيه (علم الدين)، إلا أن البطل الحقيقي في هذه الرواية هو الكتاب، كتاب (السيرة والمسيرة) كما سماه الكاتب، المخطوطة التي يتلقاها الحفيد من جده،ليعلن لنا أن رُقيّك وإرتقاءك من خلال الكتاب (القرآن), لا من خلال الأشخاص، التي قد تتلون طُرقهم في كثيرٍ من الأحيان بميولهم وأمزجتهم.
إستطاع حسانين أن يبحر بنا في العالم الصوفي الذي تحفة بعض الغمامات، العالم المبهم،العصي على الفهم إلا من مُريديه وأقطابه، لا تفكر رموزه إلا عن طريق المعرفة، التي يمتلكها المريد عن طريق القرب والتقرب، فمثلا لمحة هبوط الجد الأكبر من فوق الراحلة (كاد جسده أن ينهار، وقواه قد خارت، فاستند إلى ذراع رجل مدت إليه، وتحامل على نفسه حتى دخل المبنى، فأجلسه الذي يسنده إلى أحد جدران المكان، فرفع إليه عينيه ليرى من هذا الرجل، فوجد أمامه طيفاً لشيخ، عليه سمة الوقار يبتسم له وهو يبتعد في فضاء المكان)، هو إسقاط على بعض الأحداث التي يتلقاها الصوفي من السماء، والتي تكون علامات للرقي عنده و الوصول، وعلامات التضليل والخرافة عند بعض مناهضي هذه الفكرة.
وإستعان الكاتب في روايته على أكثر من خط بنيوي بين الإنتقال الزمني بين الماضي والحاضر والمستقبل، كما حدث في الأحداث المقروءة للجد والجد الأكبر والأحداث المتواترة بالتزامن مع الحفيد، وبين بنية غرار ألف ليلة وليلة في تفسيرات ما لا يفسر وتلميحات ببنوية إسطورية متفردة تماست - رغم البعد - والأسطورة الشعبوية البسيطة التي تنبع من العقل الجمعي المتلاحم والمتغير باستمرار، وبين رواية مبنية على غرار السير الشعبية التي إستلهمها الكاتب ليضف على الحكايات الشعبية منتجاته الفكرية وتفاسيره التي تخدم خطه الإبداعي في الرواية.
غالباً ما اتكأت اللغة على المفردات الصوفية مثل (الطيف الرباني- التجليات- النور- تشرق شمس المعرفة- نهر التجلي- يبتهل- سكينة وخضوع- أهل الصفوة- يأتي له البرهان- تغتسل بضيائه- شراب التجلي- يا رجال الهمم الشمس صعدت القمم- الغيب- أطياف - أفاض عليه- يغتسل من كربه- الكشف- الألهام - المشاهدة)، كما إستند إلى مقولات بعض الصالحين من أقطاب الطريقة مثل (وآنسني فيك النجوم برعيها.... فدرٌيها حَليٌ وبدرُ الدٌجى إلفي) للشاعر الأندلسي (يوسف بن هارون الكندي)، ومثل (الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من اقتفى أثر الرسول) (الجنيد) هو رائد حركة التصوف، أبو القاسم الجنيد بن محمد، و (لكل شئ إذا فقدته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض) لقطب الصوفية الأشهر (محي الدين بن عربي)، وغيرها الكثير، فتنهل الرواية في مجملها من هذا النبع لتتأكد فيها قدرة الصوفية على الاستمرارية، ومن هذا الاستمرارية في رأيي المتواضع قد يتسع هذا النص ليفرد له الكاتب أكثر من رواية أو متتالية، تسرد لنا تلك القماشة الدسمة وما يتعاقب عليها من الأجيال.















